
قصة ![]()
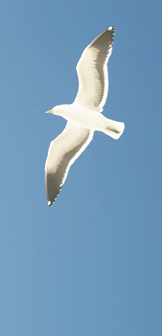 رحلت هي.. وبقيت أنا
رحلت هي.. وبقيت أنا
جدة: مها عبود أبوبكر باعشن
مع رنين الهاتف شعرت بأن خفقات قلبي تسابق الخوف, قلقة أنا من هذه المكالمة, فبالتأكيد هي مكملة لخبر أرهق نفسيتي وحطم ابتساماتي. لقد حدث ما كنت أخشاه.
فوضعت سماعة الهاتف متوجهة نحو غرفة أخي الأكبر, وأنا في حالة من الخوف والحذر.
فقال لي بهدوء وعطف: لاتخافي.. ستكون بخير إن شاء الله.
فأجبته باكية: لكني خائفة من شيء أجهله في هذه المرة.
فطلب مني التماسك والنوم, فأمامنا رحلة طويلة في الصباح الباكر.
لن أصف تلك الليلة القاسية, فهي معاناة ومأساة.. لكنها مضت رغم دموعي وأحزاني.
صحونا متوجهين نحو مطار شارل دوجال بباريس.. ثم صعدنا الطائرة في طريق عودتنا إلى مملكتنا الحبيبة. كان كلٌّ منا شارد الذهن, يتحاشى النظر إلى الآخر, وكانت الساعات ثقيلة.. باردة.. فارغة إلا من تفكير واحد.
وأخيرًا وصلنا إلى أرض الوطن, ثم توجهنا نحو المستشفى, كنت أشعر بأن المسافات تزداد طولًا وبعدًا.. حتى انتهى الطريق ووصلنا. وهأنا الآن متوقفة أمام غرفتها بالعناية الفائقة, فدخلت أنظر إليها بشوق وحزن.. مقبلة جبينها. فاقتربت مني والدتي محتضنة لي, ثم طلبت من شقيقي وشقيقتي مرافقتي إلى المنزل. وبعد وقت مضى في الطريق.. وصلنا إلى المنزل الذي لم أتمكن من الدخول إليه, فوقفت مشدوهة أمام الجميع, ثم استجمعت أنفاسي وحملت أقدامي بثقل.. وخطوت الخطوة الأولى. وعند دخولى, توقفت تحت شرفتها, فرأيت طيورها حزينة, ومقعدها فارغًا. فتابعت السير ونفسي تلهث مغصوبة خلف خطواتي, ثم توجهت نحو غرفتها, وفتحت بابها المغلق, وألقيت بنفسي فوق فراشها الخالي إلا من آثارها. فبكيت وبكيت.. والحرقة كالنار توقدها الذكرى, وقلبي يطعن بنبال كالجمر, تدميه.. تحرقه.. تفتته. فانهارت أعصابي وانهزمت قواي, فجاء الكل ملتفًا حولي, ولم أر سوى خيالات مرتبكة. فطلبت منهم تركي منفردة. فرحلوا, وبقيت أتأمل مكانها.. حاجاتها.. أجهزتها.. فرشاة شعرها وملابسها.
هي لم تغب عن بالي.. ألوم نفسي لتركها.. ليتني لم أسافر, ليتني بقيت بقربها. كنت في الماضي أتألم عند سماع كلمات الشفقة وكنت أشعر بالذنب ولا ذنب لي.
مؤمنة أنا بقضاء الله وقدره, لكن عباد الله لا ترحم.
والآن في هذه اللحظات وكأنه الحلم البعيد.. تمر في أروقة مخيلتي ذكريات من آلام السنين الفائتة. كنت أحبها ولا أفارقها أبدًا, بالكاد أذهب إلى المدرسة ويبقى قلبي وعقلي معها, وعند عودتي أقضي ما تبقى من اليوم معها.
كنت منعزلة, منطوية.. فهي كل حياتي وصداقاتي. رغم بعدها.
كان حناني نحوها متدفقًا معطاءً لاحدود له أو ثوابت. فتعلمت إطعامها وتنظيفها, وعشت معها جميع مراحل حياتها.. نموها.. عجزها ومرضها.. يومًا بعد يوم, ونهارًا خلف نهار.. ولكن كل ما نظرت إليها أشعر بالندم, لكن إيماني بالله عميق وقوي.
مسكينة هي لا تشعر بطيورها التي وضعتها لها, بل قد تشعر الطيور بسكون جسدها.
ولا تسعد بالألعاب التي حولها، فهي كغيرها من الأثاث والقطع التي أمامها, ولا تنظر إلى ساعة يدها، لأن الليل والنهار لا دقائق لهما.. حتى تلك الشرفة والكرسي. كتلة فقط بالنسبة لها, وتبقى هي سجينة هذا الفراش مع ذاك الجهاز الذي يقبض على جميع أجزاء جسدها.
ورغم كل تلك المعاناة.. لم تنس والدتي أمومتها نحوي, وذات يوم أخبرتني أن هناك من يريد التقدم لخطبتي. كنت حينها في السابعة عشر من عمري. لم أتقبل الفكرة لأني قطعت وعدًا على نفسي بأن أبقى مع شقيقتي طوال عمري, وكأني بذلك أُعزي نفسي.
فمن سيعتني بها؟ فبرغم اهتمام والدتي وحرصها على شقيقتي يظل قلقي عليها يرافقني.
لكني أخشى من أن تغفل عنها الممرضة, أو تسهو عن مواعيد أدويتها, أو تغير أوضاع جسدها. وماذا لو داهمتها أزمة الربو الشديدة ولم تلاحظ الممرضة ازرقاق لونها وضيق نفسها! فصارحت والدتي بما يجول داخل نفسي.. لكنها لم تتقبل وطمأنتني بأنها معها.
فوافقت بعد تفكير وتردد.. على رؤية المتقدم لخطبتي, ولكن الحمدلله.. قلتها في داخل قلبي قبل أن أخبر والدتي.. لم أشعر بارتياح نحوه يا أمي.
وبعد مرور الوقت, وتقدم أكثر من خاطب.. حدث ما كنت أخشاه. أعجبت بناصر وانجذبت إليه, شعرت بطمأنينة نحوه.. أحببت طريقة تفكيره.. أسلوبه.. تعليمه.. أفكاره.. وهذه المرة الأولى التي أشعر فيها بتأنيب الضمير. سألتني والدتي, فلم أرفض ولم أستطع القبول. فطلبت منها وقتًا للتفكير والاستخارة.. فشعرت بحيرتي وصراعي النفسي.. فقبلتني قائلة: سأنتظر سماع موافقتك يا ابنتي.
كم هو مؤلم ذلك الإحساس الذي أخذ يعصف بأفكاري ومخيلتي.. فكنت أحدث نفسي وألومها, أسمع صوتًا يقول لي: أنت السبب في ذبولها ومرضها.. ماذا لو كنت مكانها؟
هل ستسامحينها عندما تقرر الزواج وترحل من هنا, وتبقين أنت أسيرة هذا الفراش بسببها؟
كيف تعطين نفسك الحق بالسعادة.. بينما هي محرومة منها؟!
أين ضميرك؟ أين محبتك لها وحنوك عليها طوال تلك السنوات؟
وغيرها من الأصوات والأسئلة التي قيدتني حول دائرة الإحباط النفسي والكآبة.
فأصبحت أخشى النظر إليها من شدة العذاب وألوم نفسي آلاف المرات, عندما أتذكر الهمسات القديمة بأني كنت ضاغطة عليها ونحن أجنة، ما سبب لها نقصًا في الغذاء والأكسجين أدى إلى ضمور المخ والأعصاب.
مسكينة شقيقتي.. أحبها وأشفق عليها, هي حرمت من الحياة وحرمت أنا منها, ولكنها إرادة الله. ولكن هل أرفض ناصرًا؟ وما ذنب قلبي ومشاعري..؟ وللمرة الأولى أطلب من والدتي السماح لي بالسفر مع شقيقي فقد أبقى مع نفسي لأحاورها.
لم تتردد والدتي, ووافقت فورًا, فقد كانت تشعر بعذابي وتتفهم نفسيتي.. فسافرت أنا وشقيقي إلى فرنسا, ثم جاءنا اتصال من والدتي بأن شقيقتي تعرضت لأزمة صدرية حادة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.
وفي اليوم الخامس عدنا.. أمضيت معها عشرين عامًا, وبعدت عنها أربعة أيام.. لقد كنا روحين وجسدين, قدمنا إلى الحياة معًا.. رحلت هي.. وبقيت أنا.