
شعر ![]()
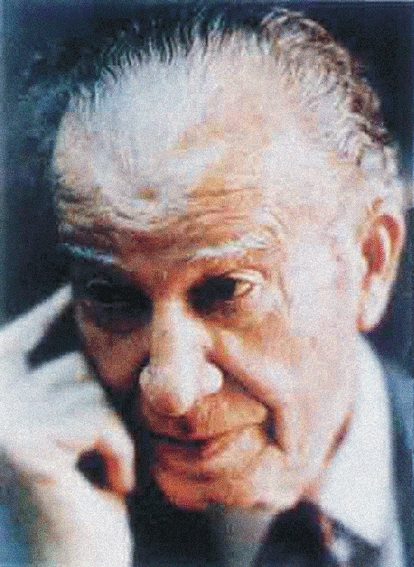 في طائرة» لعمر أبو ريشة»
في طائرة» لعمر أبو ريشة»
أبها: إبراهيم الألمعي
الشاعر
عمر أبو ريشة، شاعر سوري، ولد سنة 1910 في منبج، ومنها انتقل إلى حلب فدرس في مدارسها، ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، وفي عام 1930 سافر إلى لندن للدراسة، وهناك اطَّلَعَ على النتاج الأدبي، وبخاصة الشعري لكثير من كبار أدباء أوروبا.
وبعد عودته إلى سوريا عُين مديرًا لدار الكتب الوطنية بحلب، ثم سفيرًا لبلاده في البرازيل، ثم في الأرجنتين وتشيلي، ثم في الهند، ثم في النمسا، ثم في الولايات المتحدة.
عَقِبَ هذا التطواف بين الشرق والغرب، عاد إلى لبنان ليُقيمَ فيه، فلما نشبت الحرب الأهلية غادرها إلى الرياض، وفيها توفي سنة 1990، ونقل إلى حلب ليدفن هناك.
وهو شاعرٌ مطبوعٌ، أصيلٌ، متمكنٌ من فنون القول، له أسلوبه المميز والمنفرد، ومما يلذُّ قارئ شعره لغته العذبة، وموسيقاه التي تتناغم مع اتجاه القصيدة.
القصيدة
وثبتْ تستقربُ النجمَ مجالا | وتهادتْ تسحبُ الذيلَ اختيالا |
على هامش القصيدة:
كان الشاعر سفيرًا لبلاده في الشيلي سنة 1953، وفي إحدى رحلاته إليها، جلستْ إلى جواره، في الطائرة، حسناء إسبانية، ودار بينهما حديث، وكان حديثها رائعًا كجمالها، ما دعاه أن يسألها، أن تعرفه بنفسها، وهنا تحركت الدماءُ العربية، حتى ليراها تختال فوق أعراقِ الناس جميعًا، اعتزازًا بأجدادها وصحرائهم، التي زخرت بالمروءة والنبل والكرم، وسحر الشرق الذي عبق بنضالهم في الغرب، حيثُ نبتَ المجدُ على آثارهم، وبهذا القدر من الاعتزاز تحدَّثت عن أصولها العربية، وشاعرنا معروفٌ باعتدادهِ بعروبته، وافتخاره بإرثِ العرب والمسلمين الحضاري. ولهذا نجده يحكي أمجادهم، وتاريخهم، وحضارتهم العريقة، على لسان محدثته، راضيًا وموافقًا على قولها. ونراه في آخر بيتي القصيدة وقد سألته أن ينتسب لم يبادر إلى جوابها، ولم تطرق عيناه فحسب، بل وأطرق قلبه أيضًا؛ لأنه من أولئك القوم الذين افتخرت بهم، فهو يعرف ماضيهم وحاضرَهم، ويخشى أن تباغته فتسأله؛ عن سر تحول العرب من صُنَّاع حضارة فاعلين، إلى ما هم عليه اليوم، ويوم قيلت القصيدة، من هامشيين في الفعل الحضاري. ولم تكن مروءته وكرامته تسمحان له بالاعتراف لها، وهي الإسبانية، بهوان أمته بين الأمم، برغم الدماء العربية التي تجري في عروقها.
وتشبه هذه القصيدة في معناها ومناسبتها قصيدةَ الشاعر نزار قباني، (غرناطة) التي
مطلعها:
في مدخلِ الحمراءِ كان لقاؤنا |
ما أطـيبَ اللُّقـيا بلا ميعـــادِ |
والتي منها قوله:
قالتْ: هنا «الحمراء» زهو جدودنا |
فاقـرأ على جـدرانها أمجـادي |
* ديوان عمر أبو ريشة، 1/ (89-92) ، دار العودة، بيروت، ط1، 1988م.