
 |
تجاوز شغف السفر والارتحال لدى بعضهم حدود التنقل بين البلدان، والاستمتاع بما تقع عليه أعينهم من مناظر ومشاهد، إلى الرغبة في تدوين ما يشاهدون، بل تطورت حالة الارتحال لدى بعضهم إلى أن أصبح التدوين هدف الرحلة الرئيس الذي من أجله تجشموا عناء السفر حول العالم، حتى ينقلوا كل طريف إلى بلدانهم، ولا سيما في زمن كان الكِتاب فيه نافذة وحيدة يطل منها كل قطر من أقطار العالم على الآخر.
الرياض: أسامة الزيني
بواكير أدب الرحلة
لعل رحلة التاجر سليمان السيرافي عبر المحيط الهندي في القرن الثالث الهجري، ورحلة سلام الترجمان إلى حصون جبال القوقاز عام 227هـ، بتكليف من الخليفة العباسي الواثق، للبحث عن سدّ يأجوج ومأجوج، من بواكير الرحلات التي دونها العرب، ثم تلتها رحلات المسعودي، فالمقدسي، فالإدريسي الأندلسي، فالبغدادي.
فيما كان البيروني نسيج وحده في رحلته «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» إذ لم يكتف فيها برسم ملامح جغرافيا الهند وتاريخها، فرسم، أيضًا، بالكلمة ملامح ثقافات المجتمعات الهندية القديمة، لغة وعقيدة وعادات، مرسيًا بذلك تقاليد رائدة لأدب الرحلة. ومن الأسماء العربية الكبيرة التي يصعب تجاوزها في عالم أدب الرحلات ابن جبير الأندلسي، وابن بطوطة، ويعد الأخير أعظم رحالة المسلمين، إذ ظل يتنقل بين البلدان نحو تسعة وعشرين عامًا، ثم قفل عائدًا إلى موطنه، المغرب، ليسجل للتاريخ وقائع رحلته الشهيرة «تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» طالت أسفار ابن بطوطة في هذا الزمن المبكر، أفريقيا والهند، فضلاً عن البلدان العربية التي مرَّ بها في طريق رحلته من المغرب إلى مكة المكرمة، مقدمًا صورة شاملة دقيقة للعالم الإسلامي خلال القرن الثامن الهجري، الذي شهد بزوغ نجم هذا الرحالة المسلم الذي طبقت شهرته الآفاق، إذ كان أول من اكتشف بعض بلدان أفريقيا.
أرفف الرحالين
أثرى الرحالون العرب، المتقدمون منهم والمتأخرون، المكتبة العربية بأرفف جديدة، عامرة بقائمة طويلة وقيمة من الكتب من بينها: «خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف» للسان الدين بن الخطيب، و«نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن خلدون، و«رحلة الوزير في افتكاك الأسير» لمحمد الغساني الأندلسي، ورحلة ابن فضلان، و«الذهب والعاصفة» لإلياس الموصلي في رحلته المبكرة إلى أمريكا، و«تخليص الإبريز في تلخيص باريز» لرفاعة رافع الطهطاوي، و«الواسطة في أحوال مالطة» لأحمد فارس الشدياق، و«حديث عيسى بن هشام» ويعد من كتب الرحلات الخيالية، و«الرحلة الحجازية» للبتانوني، و«الارتسامات اللِّطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» لشكيب أرسلان، ورحلة فتح الله الصايغ الحلبي إلى بادية الشام وصحاري العراق والعجم والجزيرة العربية، و«مفاكهة الخلان في رحلة اليابان» ليوسف القعيد، و«شرق وغرب» لمحمد حسنين هيكل.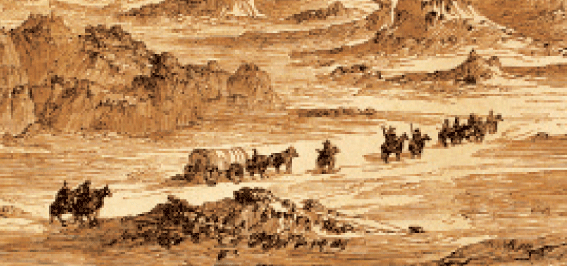
رحلات الساخرين
وقد جاءت كتب الرحلات في مجملها متباينة الأساليب والأخيلة والروح، بين رحالين مولعين برصد التفاصيل ونقل كل ما يعرض لهم من مشاهد، ورحالين أصحاب رسالة حملوا على عاتقهم عبء نقل ما يقفون عليه من ثقافات البلدان التي يقصدونها إلى شعوب بلدانهم لإثرائهم ثقافيًا ومعرفيًا، ورحالين أصحاب هدف علمي أو ثقافي أو وثائقي مثل المؤرخ السعودي حمد الجاسر الذي كانت رحلته إلى مكتبات العالم مركزة أهدافها في جمع الوثائق، ورحالين أصحاب حس ساخر نجحوا في رسم لوحات طريفة تنتزع الابتسامة من فم من يقرأ كتاباتهم، على غرار الكاتب الصحفي أنيس منصور الذي سجل مشاهداته في رحلته حول العالم في كتابه «200 يوم حول العالم». يقول أنيس منصور في مقدمة هذا الكتاب بلغة لا تخلو من رشاقة وطرافة: «ركبت البغال في أعالي الهمالايا، وركبت النفاثة من هوليوود إلى واشنطن، وكان الأمريكان ينظرون إليَّ بإعجاب وحسد، فقد كانت النفاثة شيئًا جديدًا، وركبت الفيل، وركبت زورقًا وظللت واقفًا ست ساعات، فقد كانت المياه مليئة بالأفاعي والتماسيح في أقصى جنوب الهند، وأكلت الموز بالشطة في سنغافورة، وشربت الشاي بالملح في إندونيسيا، وأكلت الأناناس مع الغربان في سيلان، وأكلت الخبز المصنوع من السمك في جزيرة بالي، وأكلت الضفادع والثعابين البرية في هونج كونج، وأكلت البيض وهو مليء بالكتاكيت، وحتى لا أصاب بقليل من القرف فإنهم في الفلبين يضيفون إليه بعض الفلفل والملح، وارتديت الدوتي في كيرالا، ولبست الكيمونو في طوكيو، ومشيت ربع عريان في هونولولو، وكان لي أصدقاء من أصحاب الملاليم، وأصدقاء من أصحاب الملايين، وكانت صداقتي لا تستغرق إلا ساعات أو أيامًا، وبعد ذلك أرحل إلى بلاد جديدة». وثمة ساخر آخر هو الكاتب حسين قدري الذي لا يملك قارئ رحلته المضمنة في كتابه «راكبان على السفينة.. رحلة إلى المحيط الأطلنطي»، أن يتوقف عن الضحك وعن التوتر أيضًا منذ الأسطر الأولى لكتابه، التي صور فيها تلك الرحلة التي كانت ستُستهل بكارثة لولا أن الله سلم، يقول قدري: «بدأت الرحلة من أول لحظة بداية سيئة، وقف لها شعر رأسي فزعًا، ليس أنا وحدي، ولكن كل من كانوا عليها، وكل المودعين الذين كانوا لا يزالون يقفون على رصيف الميناء وأيديهم لم تكف عن التلويح. فبمجرد أن تركت السفينة الرصيف وبدأت تتحرك متراجعة إلى الخلف بظهرها، لتعدل نفسها وتتوجه بمقدمتها في اتجاه البحر الأبيض، وجدنا السفينة تنطلق بظهرها بسرعة كبيرة في اتجاه سفينة أخرى أجنبية راسية في الميناء، وحين أصدر القبطان داود أمره بفرملة سفينتنا حتى لا تصطدم بالسفينة الأجنبية، تعطلت فجأة الآلات في سفينتنا ولم تستجب للفرامل، وأصبحت تسير بلا أي نوع من السيطرة أو التحكم وهي ما زالت منطلقة بظهرها بقوة الاندفاع نحو السفينة الأجنبية، لولا أن السفينة تنبهت في آخر لحظة فأدارت آلاتها بسرعة، وأسرعت بالابتعاد عن متناول سفينتنا التي مرقت إلى جانبها كالرصاصة الطائشة على بعد أمتار قليلة منها».
أما كبير الساخرين الكاتب محمود السعدني، فلا يتوقف رفيق رحلاته عن الضحك، أحيانًا لمفارقات الرحلة وملابساتها التي ينجح السعدني في اقتناصها، وأحيانًا لروح الطرفة التي تسكن كل ما يجود به مداد هذا الكاتب. يقول السعدني واصفًا رحلته من القاهرة إلى طنجة: «بدأت رحلتي من القاهرة إلى روما، ومن روما إلى مدريد، ومن مدريد إلى طنجة، لأنه كان صعبًا علينا نحن العرب أن نخترق أرض العرب، ففي ليبيا كانت هناك ثلاثة جيوش أجنبية، إنجليزية وفرنسية وأمريكية، والحدود بين مصر وليبيا مقفولة، وفي ليبيا خائن اسمه المشلح، أو المتشلح، أو الشلحاوي، يشرف على بناء سور مثل سور برلين يعزل مصر عن ليبيا. وكان دخول ليبيا للمصري أصعب من دخول إبليس الجنة».
وعن الطائرة التي أقلته من مدريد إلى طنجة يقول السعدني: «طرت في الليل من مدريد على متن طائرة إسبانية، مبطوحة ومجروحة وكما لعبة الأطفال، راحت تتأرجح وتتمرجح، وخيّل إلي وأنا في الجو أتشقلب وأتمقلب، أنني أخطأت التقدير، وبدلاً من أن أركب طائرة بمحرك واحد، ركبت طائرة بجناح واحد».